
| أحكام مجتمعية | سُنن النهوض وسؤال الهوية: لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمين؟
2025-09-25 305
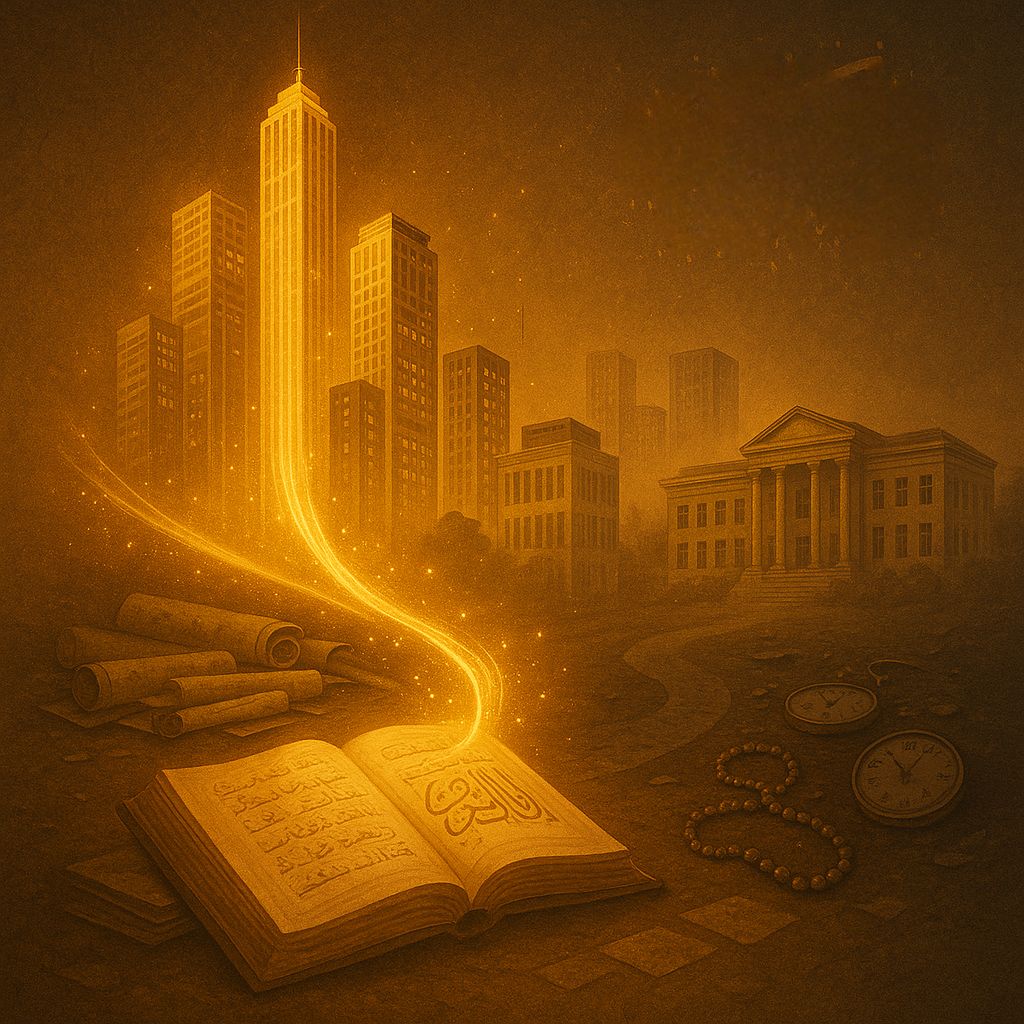
سُنن النهوض وسؤال الهوية: لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمين؟
الشيخ معتصم السيد أحمد
حين يتأمل الإنسان واقع
التقدم الغربي الهائل في مختلف المجالات، من التكنولوجيا إلى
العلوم، ومن التنظيم السياسي إلى حماية الحقوق والحريات، تتبادر إلى
الذهن تساؤلات محرجة وصادمة في آن واحد: كيف وصلت تلك المجتمعات إلى
هذا المستوى من الرقي، وهي – في الغالب – لا تؤمن بالله كما نؤمن،
ولا تلتزم بالشعائر ولا بالمرجعيات الدينية؟
ولماذا تراجع المسلمون، رغم
امتلاكهم ديناً يُفترض أنه وحي السماء وهداية البشر؟ هل النهضة
مشروطة بالإيمان؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا لم تظهر آثارها في مجتمعات
يُفترض أنها تدين بالإسلام؟ وإن لم تكن، فهل هذا يُضعف موقع الدين
في مشروع النهوض الإنساني؟
هذه التساؤلات، على عمقها، تكشف في
الحقيقة عن إشكال مفاهيمي شائع، يتعلق بفهم العلاقة بين الإيمان
والعمل، بين العقيدة والحضارة، بين السنن الإلهية والواقع التاريخي.
وللإجابة عنها لا يكفي أن نقتبس آية أو نرفع شعاراً، بل ينبغي الغوص
في فهم السنن الحضارية التي تحكم قيام الأمم وسقوطها، وتحليل
التجارب الواقعية من خلال منظار قرآني شامل.
التقدّم الغربي: ثمرة تحوّل
داخلي
ما حدث في أوروبا منذ ما يُعرف
بـ"عصر النهضة" لم يكن لحظة مفاجئة أو نتيجة قرار سياسي عابر، بل
كان ثمرة تحوّل تراكمي في البنية العقلية والثقافية للإنسان الغربي،
بدأ منذ القرن الثاني عشر وتراكم عبر حركات الإصلاح الديني،
والثورات العلمية، والاكتشافات الجغرافية، وانتهى بتبلور نموذج
حضاري جديد يعتمد على الإنسان الفاعل، والعقل المنتج، والنظام
المؤسساتي الفعّال.
صحيح أن هذا التحول تزامن مع تراجع
سلطة الكنيسة والإقصاء التدريجي للدين من المجال العام، لكن اختزال
النهضة في "العلمانية" هو نوع من التبسيط المُخل. فالعبرة ليست فقط
في كون الدين حُيّد أو لا، بل في أن الإنسان الأوروبي غيّر ما
بنفسه: فكّر بطريقة جديدة، نظّم علاقاته، استثمر المعرفة، بنى
مؤسساته، واحترم قوانين العمل والبحث والاجتهاد. لقد أحدث "ثورة في
الإنسان"، وبهذا تحقق التغيير في الخارج.
الإسلام ودوره في النهضة
من المفارقات أن النموذج الغربي
المعاصر – رغم ادعائه القطيعة مع الدين – هو في كثير من قيمه
وتجربته قريب من الروح الإسلامية في جانبها الحضاري. الإسلام لا
يُعارض العقل، ولا يُهمّش العلم، ولا يمنع بناء الدولة والمؤسسات،
بل هو دين يدعو إلى عمارة الأرض، ويحث على التفكير والنظام
والاجتهاد. بل إن القرآن ذاته يضع قانوناً صريحاً لسنن التغيير حين
يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾.
هذه الآية ليست وعداً سحرياً
بالتغيير الفوري، وليست أيضاً شرطاً متعلقاً حصرياً بالإيمان
العقائدي، بل هي بيان لسنة كونية شاملة: الله لا يُحدث تحوّلاً
حضارياً في أي مجتمع، ما لم يُبادر ذلك المجتمع إلى إصلاح ذاته،
وتغيير نمط تفكيره، وبناء قدراته الداخلية. فالإيمان وحده، دون عمل
وعقل ونظام، لا يصنع حضارة، تماماً كما أن امتلاك الثروة الطبيعية
دون إدارة سليمة لا ينتج تقدماً.
ومن هنا يتضح أن تجربة الغرب لا
تُعدّ دليلاً ضد الدين، ولا تفنيداً للقرآن، بل تأكيداً على أن من
أخذ بأسباب النهوض تغيّر حاله، حتى وإن لم يكن متديناً. وفي
المقابل، من ترك تلك الأسباب، وتواكل على الدعاء أو عوّل على
الماضين، فلن تقوم له قائمة، وإن رفع شعار الدين ليل نهار.
أزمة التديّن المعاصر: انفصال بين
الإيمان والعمل
المشكلة في كثير من مجتمعاتنا
الإسلامية ليست في غياب الإيمان، بل في انفصال الإيمان عن الفعل
الحضاري. لقد تحوّل الدين عند البعض إلى منظومة شعائرية منعزلة، أو
إلى خطاب دفاعي يبرّر التخلف باسم القضاء والقدر، دون أن يترجم
الإيمان إلى قيم إنتاجية: كالنظام، والانضباط، والبحث العلمي،
واحترام الوقت، وبناء المؤسسات، والانفتاح على العالم.
ولذلك، فحتى حين تُطرح الآية
الكريمة في النقاش، فإن البعض يقرؤها قراءة سطحية، لا تمتد إلى عمق
النفس والمجتمع. فالتغيير المطلوب ليس مجرد التوبة من الذنوب
الفردية، بل إعادة تشكيل الوعي الجماعي، والتحرر من الكسل الحضاري،
وتجاوز التبعية الفكرية، وامتلاك زمام المبادرة في كل ميادين
الحياة.
من المغالطات الشائعة أن يُقال:
"الغرب تقدّم لأنه تخلّى عن الدين، وعلينا أن نفعل الشيء ذاته". هذه
المقولة تُغفل طبيعة التجربة الدينية في السياق الأوروبي، والتي
تميّزت عبر قرون طويلة بالاستبداد الديني، وتسلّط الكنيسة على العلم
والسياسة والمال. في المقابل، فإن الإسلام – في أصله – لم يكن يوماً
خصماً للعلم ولا عائقاً أمام الحرية، بل هو الذي أسّس لحضارة علمية
وإنسانية شهد لها الجميع، وكان سبباً في إشعال جذوة النهضة الغربية
نفسها من خلال الترجمة والاحتكاك الحضاري.
الفرق أن الغرب أجرى نقداً داخلياً
لتجربته واستخرج منها نموذجاً جديداً، أما المسلمون فلم يُراجعوا
تجربتهم كما ينبغي، بل وقفوا إما عند التقديس الجامد للماضي، أو عند
الانبهار الأعمى بالغرب، دون بناء رؤية متكاملة تتفاعل مع العصر من
منطلق الثقة بالإسلام كمنظومة حضارية.
من أين يبدأ التغيير
الحقيقي؟
إذاً، التغيير لا يبدأ من الخارج،
ولا من الأنظمة السياسية فقط، بل يبدأ من داخل الإنسان نفسه: من
فكره، وسلوكه، وموقفه من ذاته ومن العالم. الإسلام لا يُعوّض
التقاعس بالمعجزات، ولا يعطي وعوداً فارغة، بل يقول: ابدأ أنت
أولاً. غيّر نفسك، يتغيّر واقعك.
ولهذا، فإن أخطر ما أصاب المسلمين
هو فقدان الثقة بالنفس، والإحساس بالدونية أمام الغرب، وكأننا غير
قادرين على إنتاج حضارتنا الخاصة، وكأن الإسلام لا يصلح أن يكون
قاعدة للنهوض من جديد. وهذا – في الحقيقة – أحد أخطر آثار الاستعمار
المعنوي والثقافي، الذي جعلنا نستورد النماذج بلا نقد، ونستهلك بلا
إنتاج، ونلبس الحداثة في قشورها دون امتلاك روحها.
فالحل لا يكمن في استنساخ الغرب،
ولا في اجترار الماضي، بل في بناء مشروع حضاري متوازن، يتكامل فيه
الإيمان والعقل، القيم والعمل، الروح والمادة. مشروع يعيد للإسلام
دوره كمحرّك للنهضة، لا كعائق لها، ويعيد للإنسان المسلم ثقته بنفسه
وبقدرته على بناء نموذج مختلف: إنساني، عادل، منتج، ومتجذّر في
قيمه.
وحتى يتحقق ذلك، لا بد من إصلاح
التعليم، وتحرير العقل، وبناء مؤسسات تحترم الكفاءة، وتنمية روح
المبادرة، وربط الدين بالحياة لا بعزلته عن الواقع. فالدين الذي لا
يصنع إنساناً منتجاً، ولا يغيّر سلوكاً فاسداً، ولا يحرّك وعياً
نائماً، يصبح عبئاً على النهضة لا ركيزة لها.
خاتمة
في ضوء ما تقدم، يمكن القول إن
التقدّم الغربي لا يتعارض مع الآية الكريمة ﴿إِنَّ اللَّهَ لا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾، بل
هو تطبيق عملي لها. أما تأخّر المسلمين فليس بسبب تمسّكهم بالدين،
بل بسبب عزلهم له عن الحياة، وفشلهم في تفعيل قيمه كقوة دافعة
للتغيير. ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا تقدّم الغرب؟ بل:
متى ينهض المسلمون من جديد؟ وكيف يغيّرون ما بأنفسهم ليُغيَّر ما
بهم؟
هذا هو جوهر المسألة، ومفتاح التحول الحضاري القادم.
الأكثر قراءة
37356
19937


