
2025-08-24 1087
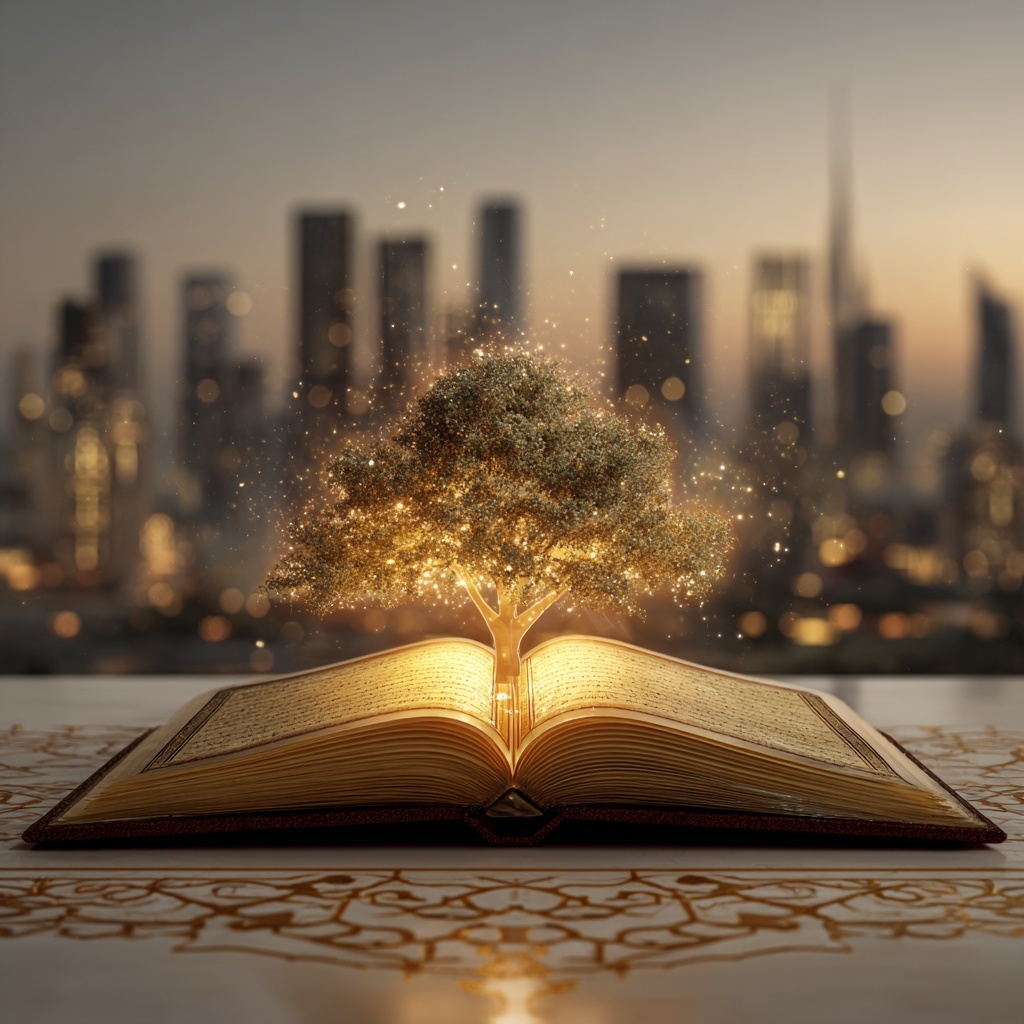
التجديد في الخطاب الإسلامي: بين ثبات القيم وتحولات الواقع
الشيخ معتصم السيد أحمد
تُثار كثيراً في الساحة الثقافية
والفكرية المعاصرة مسألة "التجديد في الإسلام"، ويكاد لا يخلو نقاش
ديني اليوم من هذه الكلمة، حتى أصبحت تهمة أحياناً وضرورة في أحيان
أخرى. لكن ما المقصود بالتجديد؟ وهل يعني نسف التراث؟ أو تغيير
الأحكام؟ أم أنه دعوة لفهم متجدد للدين نفسه؟ وما علاقة التجديد
بالزمان والمكان؟ ومن أين يبدأ، وما ضوابطه؟
إذا أردنا أن نتناول مفهوم التجديد
ضمن المنظور القرآني والرسالي، فإن أول ما يجب التنبيه إليه هو أن
الإسلام دين خالد، وصلاحيته لكل زمان ومكان لا تعني أن أحكامه ثابتة
كلياً، بل إن ثبات القيم فيه يقابله حركية في التطبيق، وحيوية في
الفهم، واستعداد دائم للتفاعل مع المتغيرات الزمانية والمكانية. ومن
هنا فإن التجديد لا يعني المساس بجوهر الدين وثوابته، بل يعني أن
يكون الخطاب الإسلامي متناسباً مع السياق المتغير للحياة
الإنسانية.
بعبارة دقيقة: التجديد هو تحريك
أدوات الفهم الديني لتواكب الواقع، لا تحريف النصوص لترضى عنها
الوقائع. وهو إعمال للعقل ضمن إطار الوحي، واستحضار للقيم الخالدة
في ضوء الحاجات المتجددة. فالإسلام لم يُنزّل ليكون ديناً متحجراً،
بل رسالة تنبض بالحياة، تتجاوز العصور دون أن تُسحق تحت
ركامها.
العقل والوحي: علاقة تكامل لا
تضاد
من أبرز خصائص الإسلام أنه لم يفصل
العقل عن الوحي، بل جعل العلاقة بينهما علاقة تكاملية. فالوحي يُمثل
المصدر الإلهي الذي يكشف القيم والحقائق الكبرى، والعقل هو الأداة
التي يُفترض أن تكتشف الواقع وتربط هذا الواقع بقيم الوحي. فلا يمكن
للوحي أن يحقق هدفه من دون العقل الذي يفهمه، كما لا يمكن للعقل أن
يهتدي إلى الحق دون هدى الوحي.
فإذا أردنا أن نجدد، فالمفتاح
الأول هو العقل. لكن العقل ليس عقلاً منفلتاً أو متحرراً من كل قيد،
بل عقل منضبط بالقيم، عقل لا يتحرك خارج روح الشريعة، بل يعمل داخل
دائرتها ليكتشف في كل زمن "أحسن ما يُقال" و"أفضل ما يُفعل".
إن الشريعة الإسلامية نفسها تضع
العقل في موقع القيادة الفكرية، وتدعوه بوضوح إلى التعقل والتدبر
والتفكر، لا بوصفه تابعاً خاضعاً للنصوص بشكل آلي، بل باعتباره
شريكاً أساسياً في استنباط الأحكام، وفهم الواقع، وربط النص بالظرف.
فالإسلام لا يعامل الإنسان ككائن منفعل، بل يريده أن يكون فاعلاً،
مسؤولاً عن قراراته واختياراته، ولهذا جعل من العقل مناط التكليف،
وجعل الفقهاء يشترطون العقل في كل أمر تعبدي، لأن فهم الدين لا
يتحقق إلا به.
بل إن الشريعة الإسلامية – في
عمقها – لا تكتفي بإبراز العقل كأداة للفهم، بل تمنحه مسؤولية
اكتشاف المصالح والمفاسد بحسب تغير الأحوال والظروف، في إطار مقاصدي
يوازن بين النصوص والقيم الكبرى التي جاءت بها الرسالة. فالمصلحة
ليست شيئاً منفصلاً عن الدين، بل هي جزء من بنيته، والواقع ليس
عدواً للوحي، بل ميدانه الحيوي.
ولذلك لا يُعلّق الإسلام حركة
العقل على جدران النصوص الجامدة، ولا يُقيّده بفهمٍ ماضٍ لا يتغير،
بل يدفعه إلى التفاعل مع الحياة في ضوء الوحي، ويحمّله أمانة
الاجتهاد، وتجديد الوسائل والمقاربات بما ينسجم مع الأهداف العليا
للشريعة. وبذلك يصبح التجديد ضرورة نابعة من طبيعة الإسلام نفسه، لا
مجرد استجابة لضغط الواقع أو محاولة لمجاراة الحداثة، بل هو امتداد
عضوي لروح الدين التي تجعل من الإسلام رسالة حية تتفاعل مع الإنسان
وزمانه، دون أن تفقد هويتها أو تنفصل عن مقاصدها.
قد يُظن أن التجديد ضرورة فرضتها
الظروف المعاصرة، أو أنه ترف فكري نمارسه تحت ضغط الحضارة الغربية،
لكن الحقيقة أن التجديد في الإسلام ليس طارئاً ولا دخيلاً، بل هو
جزء من منطق الرسالة الخاتمة. فدينٌ يُفترض به أن يكون صالحاً لكل
زمان ومكان لا بد أن يتضمن في بنيته الداخلية ما يتيح له أن يتجدد
في كل عصر.
وهذا المعنى تجسده آيات القرآن
التي لا تحث فقط على استعمال العقل، بل تجعل "اتباع الأحسن" منهجاً،
كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾. وقوله: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا
الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.
فالقرآن لم يطالبنا باتباع القول
الحسن فحسب، بل الأحسن، وهذا دليل على أن العقل له القدرة على معرفة
ذلك، ففتح الباب أمامه ليفاضل بين الأقوال والأفعال، ومن ثم اختيار
الأصلح وفق متغيرات الواقع، دون الخروج عن ثوابت الدين.
فالآيتان السابقتان تشيران إلى أن
المؤمن الحقيقي هو من يُحسن الاستماع، ثم يُحسن الاختيار، فيأخذ بما
هو "أحسن". والأحسن كما هو معلوم يتغير تبعاً للزمان والمكان
والمصلحة، ومع ظروف الإنسان المتغيرة.
ونلحظ ذلك في قوله تعالى: ﴿خُذِ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، فالثابت بالضرورة أن العرف ليس
شيئاً ثابتاً، بل هو ما تعارف عليه الناس من الخير، في سياقهم
وزمانهم، ما دام لا يخالف الشريعة. ومن هنا ذهب كثير من الفقهاء إلى
اعتماد العرف كمصدر مهم في فهم الأحكام، لأنه يمثل "العقل الجمعي
المتحرك" للأمة.
وكذلك قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ... يُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾. فالحكمة هنا ليست فقط معرفة النصوص، بل
القدرة على التعامل معها بوعي، وربطها بالواقع، واستنباط الأحكام
منها بحسب الحوادث المتجددة، وهو ما يعني أن "الحكمة" هي المفتاح
الحقيقي لخلافة الإنسان، وإدارته المتجددة للحياة.
تحطيم الاصنام المعرفية
التجديد يتطلب قبل كل شيء شجاعة
فكرية في كسر ما أشار إليه القرآن بـ"أصنام التقاليد"، كعبادة
الآباء، أو الخوف من المجتمع، أو التبعية للسلطة، إذ إن أخطر ما
يعوق انبعاث العقل وحرية الوعي ليس الجهل، بل القداسة المزيّفة التي
تُمنح للماضي أو للواقع الفاسد. ولذلك خاض القرآن معركة طويلة مع
هذه الأصنام، لأنها كانت ولا تزال من أبرز العقبات أمام انطلاق
الإنسان نحو التحرر الفكري والديني.
فعلى سبيل المثال، لم يكن التبرير
الذي قدّمه المعاندون للدعوة النبوية قائماً على ضعف الحجة أو
ضبابية الرسالة، بل كان قائماً على الخوف من تغيير الواقع ومغادرة
المألوف، قال تعالى: ﴿إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ أَرْضِنَا﴾ (القصص: 57)، وهو تبرير يعكس عقلية ترى في الواقع
حصناً لا يجوز مغادرته، حتى لو كان هذا الواقع ظالماً أو متخلفاً.
فالخوف من المجتمع، ومن فقدان الامتيازات أو الاصطدام بالتيارات
السائدة، هو أحد الأصنام التي يحذر منها القرآن، لأنها تُخضع الحق
لموازين القوة لا لموازين العقل.
وكذلك لم يتردد القرآن في كشف
استبداد السلطة السياسية وأثرها في تعطيل وعي الناس، كما في قوله
تعالى عن فرعون: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (الزخرف: 54)، فالطغيان لا يحتاج إلى
كثير من الذكاء بل إلى كثير من الجبن في الناس، حين يسمحون لأنفسهم
أن يُقادوا ويُستذلوا باسم الأمن أو العادة أو الزعامة. والآية هنا
تفضح بنية الطغيان: تزييف للوعي واستثمار في الجهل.
بل إن من أبرز مظاهر تقديس الواقع
هو التمسك بالتراث دون فحصه أو إخضاعه للعقل، وتقديس ما يسمى بـ"سلف
الأمة" دون النظر إلى مقولاتهم في سياقها التاريخي وظروفها
المتغيرة. وقد أشار القرآن إلى هذا التعلق المرضي بالأسلاف في قوله
تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ
مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾
(الزخرف: 23)، وهو موقف يعكس كيف يتحول التقليد إلى عقيدة، والجمود
إلى مبدأ، بينما يجادلهم القرآن قائلاً: ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم
بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾، أي أن الهداية
الحقيقية قد تكون في كسر الموروث، لا في اجتراره.
وعليه، فإن التجديد يبدأ حين نكفّ
عن عبادة الماضي ونكفّ عن الخوف من الحاضر، ونبدأ في فحصه، ونفكك ما
يجب تفكيكه، ونُبقي ما لا يزال صالحاً ومُلهِماً. فالماضي ليس
معصوماً، والمجتمع ليس مرجعاً في الحقيقة، والسلطة ليست وصيّة على
الوعي. ومن هنا فإن معركة التجديد هي أولاً معركة تحرير الوعي،
وتفكيك الأصنام المعرفية التي تراكمت في الثقافة الإسلامية بفعل
الخوف والتقليد والاستبداد.
في مقابل هذا كله، من المهم أن
نُدرك أن التجديد لا يعني الانفلات، ولا يعني خرق ثوابت الدين، ولا
اللعب بنصوص الوحي تحت شعار "الحداثة". بل التجديد في الإسلام مؤطر
بثلاثة محددات:
ثبات القيم القرآنية الأساسية: مثل
العدل، التوحيد، الكرامة، الحرية، التكافل... مضافاً إلى تشريعاته
العبادية.
انضباط الفهم بمقاصد الشريعة: أي
فهم النص في ضوء أهدافه الكبرى لا في قوالبه الجزئية فقط.
الاحتكام للعقل المنضبط لا الهوى
المنفلت: فالعقل هنا شريك في الفهم، لا سيدٌ مطلق.
في الختام، إننا لا نبالغ إذا قلنا
إن التجديد ليس مجرد حاجة آنية تفرضها ضغوط العصر، بل هو شرط ضروري
لبقاء الدين نفسه حيّاً، فالدين الذي لا يتجدد يموت، والشريعة التي
لا تُفهم في سياق الحياة تتحول إلى طقوس شكلية بلا روح. ولذلك فإن
التجديد الحقيقي ليس ترفاً فكرياً، بل جزءٌ من طبيعة الإسلام كدينٍ
خاتم، يتوجه إلى الإنسان في كل زمان، ليقوده نحو الحق في ضوء العقل،
ويهديه في مسارات الواقع من خلال القيم الثابتة.
إن التجديد، في النهاية، هو وفاء لروح الإسلام لا خيانة لنصوصه، وهو تعبير عن حيوية الرسالة لا تفريط في جوهرها، وإذا أحسنّا تفعيله، فلن يكون سبباً للتمرد على الدين، بل سيكون طريقاً للعودة إليه بحيوية أكبر ووعي أعمق.
الأكثر قراءة
37372
19938


