
| تأريخ الإسلام | مستقبل الرسالة بعد الرسول: أزمة الخلافة وسؤال المستقبل
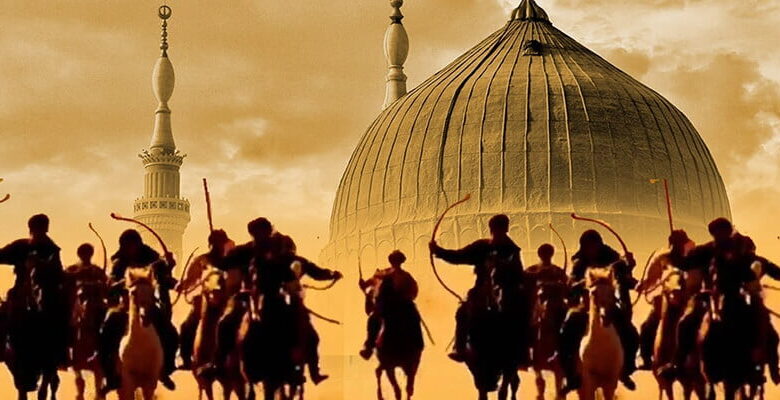
مستقبل الرسالة بعد الرسول: أزمة الخلافة وسؤال المستقبل
الشيخ معتصم السيد أحمد
شكّل الإسلام عند ظهوره تحولاً
سياسياً عظيماً في جزيرة العرب، لم تعرف له مثيلاً من قبل. فقد كانت
القبائل العربية تعيش في حالة من التنافر والتناحر، بلا أي شكل من
أشكال الحكم المركزي أو الإدارة المنظمة. وكانت ثقافة الغزو والنهب
سيدة الموقف، حيث تهاجم القبائل القوية نظيرتها الأضعف، وتسلب منها كل
ما تملك، في غياب تام لأي منظومة تشريعية أو مؤسساتية تضبط العلاقة
بين الناس.
ولم يكن لدى العرب قبل الإسلام من
مظاهر النظام السياسي إلا ما ندر من أحلاف وتفاهمات قبلية، مثل "حلف
الأحابيش" و"حلف المطيّبين" و"لعقة الدم" وأشهرها "حلف الفضول"، وكلها
لم تكن سوى محاولات بدائية لتطويق الفوضى والاحتكام إلى الحد الأدنى
من التضامن القبلي، وغالباً ما كانت محصورة في مكة أو بين
قبائلها.
وقد لخّصت السيدة فاطمة الزهراء بنت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الواقع الجاهلي، في خطبتها
الشهيرة التي ألقتها بعد وفاة أبيها، حين قالت تصف حال العرب قبل بعثة
النبي: «وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطامع،
وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون القدّ والورق،
أذلّة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى
بمحمد (صلى الله عليه وآله)...» (الاحتجاج، ج1، ص131-146).
بهذا الخطاب البليغ، وصفت الزهراء
(عليها السلام) النقلة الحضارية الكبرى التي أحدثها الإسلام، وكيف
تحول ذلك المجتمع الممزق إلى أمة واحدة، تدين بالله الواحد، وتخضع
لقيادة رسوله، وتعيش تحت راية الشريعة، حيث العدل والمساواة، والكرامة
والحرية.
لقد استطاع النبي الأكرم (صلى الله
عليه وآله) أن يُحدث تحوّلاً جذرياً في بنية المجتمع العربي، فحوّل
المدينة المنورة من مجرد بلدة متفرقة الأهواء والاتجاهات إلى أول
حاضرة إسلامية قائمة على أسس ثابتة من العقيدة والعدل والتنظيم
السياسي والاجتماعي. كانت المدينة تمثّل قبل هجرته مجرّد ساحة
للتجاذبات القبلية والصراعات المحلية، ولكن بفضل قيادته الإلهية أصبحت
مركزاً متماسكاً لبناء أمة جديدة، تتجاوز الروابط القبلية والعصبيات
الموروثة، وتتوحد تحت راية الإسلام وقيمه ومبادئه. فقد أراد النبي
(صلى الله عليه وآله) أن يؤسس مجتمعاً تسوده الأخوّة، ويقوم على مبدأ
التوحيد والمساواة، لا على أواصر الدم والنسب.
ومن هنا، لم تكن الدولة الإسلامية
التي تأسست في المدينة مجرّد تجربة عابرة أو كيان طارئ فرضته اللحظة
التاريخية، بل كانت مشروعاً حضارياً مقصوداً يحمل في طياته رسالة
عالمية ومهمة تاريخية عظيمة. ولذلك، فإن هذه التجربة لم تكن ملكاً
لجيل الصحابة فقط، بل مسؤولية تاريخية تقع على عاتق جميع المسلمين في
كل عصر. ومن الطبيعي والمنطقي أن يتظافر المسلمون بعد وفاة النبي (صلى
الله عليه وآله) للحفاظ على هذا المشروع العظيم، والدفاع عن أسسه
ومقوماته، واستكمال مسيرته، لا أن يتركوه يتفكك أمام الصراعات
السياسية والأنانيات الشخصية، أو يفرّطوا به تحت تأثير الصدمة أو
تسليماً لأهواء الطامحين إلى السلطة.
فقد كان الإسلام مشروعاً إنقاذياً
عالمياً، أخرج الناس من ظلمات الجهل والعبودية والانقسام، إلى نور
الهداية والعقل والوحدة. والتفريط بهذا المشروع بعد وفاة مؤسسه، أو
ترك مصيره للأهواء والتقديرات الشخصية، هو نكوص عن تلك النقلة
الحضارية، وخيانة للمسؤولية التي حملها النبي على عاتقه طوال حياته،
وضحّى من أجلها بكل ما يملك.
فالرسالة الخاتمة، التي بعث بها
النبي إلى العالمين، لا يمكن أن تُحصر بزمن حياته، بل هي مشروع مستمر
يتطلب من المسلمين أن يعملوا على صيانته وتطويره، ونقله من جيل إلى
جيل. وقد بدأ النبي فعلياً التأسيس لذلك الامتداد، حين بشر أصحابه
بفتح بلاد فارس والروم، وأرسل الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى
الإسلام، ويؤكد أن الرسالة التي يحملها ليست محلية ولا قومية، بل
عالمية وعابرة للحدود.
ولذلك فإن سؤال "من يقود الأمة بعد
النبي؟" لم يكن سؤالاً ترفياً أو نزاعاً سلطوياً، بل كان جزءاً من
التفكير الجاد في مستقبل المشروع الرسالي، لأن المهام التي كان يقوم
بها الرسول (صلى الله عليه وآله) لم تقتصر على التبليغ، بل شملت
التربية والتعليم، وتنظيم المجتمع، والاحتكام بين الناس، وقيادة
الجيوش، وإدارة الدولة، وتأسيس منظومة قيمية متكاملة.
من هنا، كانت الحاجة ماسة إلى صيغة
واضحة تحمي الرسالة من التشتت والضياع بعد رحيل النبي. وكان الخلاف في
كيفية ضمان هذا الامتداد السياسي والقيادي أحد أعظم محاور النزاع بين
المسلمين لاحقاً. فبينما تمسك جمهور أهل السنة بفكرة "الشورى" كآلية
لاختيار الخليفة، أو الحكم لمن غلب بالسيف، رأى أتباع مدرسة أهل البيت
أن القيادة لا يمكن أن تُترك للاجتهاد البشري المتروك للظروف
السياسية، بل يجب أن تكون بنصٍّ من النبي وتعيين إلهي، لأنها امتداد
للنبوة في وظيفتها وإن لم تكن نبوة في ذاتها.
وقد ناقش الشهيد محمد باقر الصدر هذا
التباين بدقة في كتابه المهم "بحث حول الولاية"، حيث تناول بالتحليل
والنقد كل من احتمالات: عدم التعيين، التعيين العام، والتعيين الخاص،
وبيّن كيف أن التعيين الخاص، الذي يتم بإشارة مباشرة من النبي إلى من
يخلفه، هو الضامن الوحيد لاستمرار الرسالة دون انحراف، خاصة وأن
الإسلام دين خاتم، لا يُنتظر بعده نبي آخر لتصحيح الانحراف أو إعادة
التأسيس.
إن ما حدث بعد وفاة الرسول من اضطراب
في ترتيب الأولويات السياسية، وانتقال مفاجئ للسلطة، يؤكد أن غياب
رؤية موحدة أو معلنة للمستقبل السياسي كان من أخطر التحديات التي
واجهت الأمة الناشئة. وهذا ما يفرض علينا اليوم، ونحن نعيد قراءة تلك
المرحلة، أن نفهمها لا بوصفها مجرد نزاع على الحكم، بل بوصفها لحظة
مفصلية في تاريخ الأمة، تقرر فيها مصير المشروع الإسلامي كله: هل يبقى
وفياً لمبادئه؟ أم يتحول إلى مجرد سلطة يتنازعها الطامعون باسم
الدين؟
إن السؤال عن خلافة الرسول هو سؤال
عن مستقبل الدين نفسه: هل يُدار بمنظومة قيمية رسالية متكاملة؟ أم
بمنطق الغلبة والانتصار السياسي؟ وهذا هو السؤال الذي ما زال صداه
يتردد حتى يومنا هذا.
وفي الختام، إن العودة إلى لحظة ما
بعد رحيل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ليست مجرد عودة تاريخية،
بل هي استدعاء لسؤال مصيري ما زال يُلقي بظلاله على واقع الأمة: كيف
يمكن للدين أن يستمر بوصفه مشروعاً حضارياً شاملاً، إذا انفصلت قيادته
عن منطق الرسالة، وتحوّلت إلى صراع على السلطة؟
لقد حاولنا هنا تسليط الضوء على
أهمية التفكير في "المستقبل الرسالي للرسالة" باعتباره جزءاً من صميم
المشروع النبوي، لا أمراً خارجاً عنه. فالنبي لم يكن مبلّغاً فحسب، بل
كان قائداً ومربياً ومهندساً لمجتمع جديد، وبالتالي فإن غيابه لا يمكن
أن يُترك بلا امتداد مؤسّسي شرعي قادر على حمل هذه الوظيفة من
بعده.
وإذا كان التاريخ قد شهد تبايناً بين
خيار التعيين وخيار الشورى، فإننا بحاجة اليوم إلى تجاوز السجالات
المذهبية السطحية، والدخول إلى عمق السؤال: ما هي الضمانة الحقيقية
لاستمرار الإسلام كمشروع تحرري وقيَمي، لا مجرد هوية شكلية؟ وهل يمكن
فصل القيادة السياسية عن المرجعية الروحية والتشريعية التي جسدها
النبي الأكرم في حياته؟
وعليه، فإن من أهم التوصيات التي
نخرج بها من هذا النقاش:
• ضرورة إعادة قراءة تاريخ الخلافة المبكّرة من
زاوية "المشروع الرسالي"، لا من زاوية الغلبة أو المشروعية الشكلية
فقط.
• توسيع النقاش المعرفي والفكري حول مفهوم الإمامة
والخلافة في سياق مقاصد الرسالة، لا في إطار الجدال الفقهي أو السياسي
الضيق.
• التأسيس لوعي إسلامي جديد يُدرك أن مستقبل الدين
مرهون بطبيعة القيادة التي تحمله، وأن الانحراف السياسي عن المبادئ هو
بداية انحسار الروح الرسالية في المجتمع.
فالمشكلة لم تكن في فقدان القيادة
فحسب، بل في فقدان الوعي بضرورة استمرارها على نفس النهج النبوي. وهذا
ما يجعل مسألة الخلافة والإمامة ليست حدثاً تاريخياً مضى، بل سؤالاً
مفتوحاً على المستقبل.


